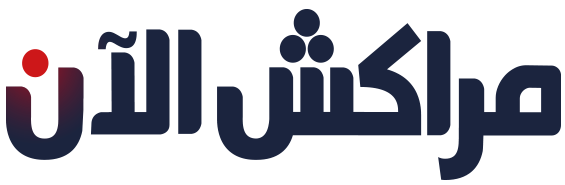الدكتور بنطلحة يكتب: النظام الجزائري يسير صوب الباب المسدود .. والانهيار يبلغ الحدود القصوى

د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء
في مشهد يبدو للوهلة الأولى سورياليًا، تخرج الجماهير الجزائرية إلى الشوارع في احتفال صاخب، تُرفع فيه الأعلام وتتعالى الهتافات، لا ابتهاجًا بانتصار منتخبها الوطني، ولا احتفاءً بإنجاز يخصها، بل احتفالًا بهزيمة المنتخب المغربي.
الفرح هنا لا ينبع مما تحقق في الداخل، بل مما تعثر في الخارج. إنه احتفال بلا إنجاز، ونشوة بلا فاعل ذاتي، وكأن خسارة الآخر تمنح الجماعة لحظة امتلاء رمزي تعجز الوقائع المحلية عن توفيرها. هذا المشهد، في كثافته الرمزية، لا يمكن اختزاله في رد فعل رياضي عابر، بل يطرح سؤالًا أعمق: ما الذي يدفع مجتمعا إلى تحويل فشل غيره إلى مناسبة فرح جماعي؟ وما الذي يخفيه هذا السلوك من اختلالات داخلية؟
لفهم هذه الظاهرة، لا يكفي الاكتفاء بتفسيرات انفعالية أو أخلاقية، بل يتطلب الأمر مقاربة تحليلية تتجاوز الحدث إلى البنى النفسية والسياسية التي تُنتجه.
فمنذ عقود، لم يعد ممكنًا تحليل بعض الديناميات السياسية المعاصرة بالاعتماد الحصري على المقاربات الكلاسيكية التي تركز على البنى الدستورية أو المؤشرات الاقتصادية أو توازنات القوة الظاهرة، دون استحضار الأبعاد النفسية والرمزية التي تسهم في تشكيل السلوك السياسي فرديًا وجماعيًا.
في هذا السياق، تبرز المقاربة السيكو-سياسية (Political Psychology / Psychopolitics) بوصفها حقلاً معرفيًا عابرًا للتخصصات، يتقاطع فيه علم النفس، والعلوم السياسية، وعلم الاجتماع، لفهم منطق الفعل السياسي حين يتجاوز الحساب العقلاني للمصالح نحو أنماط إدراكية وانفعالية أكثر تعقيدًا.
تنطلق هذه المقاربة من فرضية مفادها أن الدولة، باعتبارها فاعلًا سياسيًا، لا تُختزل في أجهزتها ومؤسساتها، بل تعكس أيضًا بنية نفسية جماعية تتغذى من الذاكرة التاريخية، والهوية، وتجارب النجاح أو الإخفاق المتراكمة. وقد ساهم في تأصيل هذا المنظور مفكرون وباحثون مثل فرويد في تحليله لسيكولوجيا الجماهير، ولاسويل في ربط السلطة بالدوافع النفسية، وفستنغر من خلال مفهوم التنافر المعرفي (Cognitive Dissonance)، إضافة إلى تاجفيل في تفسيره لمنطق الهوية الجماعية، وفوكو في تحليله لعلاقة السلطة بالخطاب.
ويعد التنافر المعرفي أحد المفاتيح المركزية لفهم السلوك السياسي في مثل هذه الحالات. فحين تتشكل لدى جماعة ما صورة ذاتية إيجابية عن نفسها (دولة عظمى، مكة الثوار، القوة الضاربة)، ثم تصطدم هذه الصورة بواقع مليء بالإخفاقات، ينشأ توتر نفسي يصعب تحمله.
هذا التوتر لا يُعالج غالبًا عبر مراجعة الاعتقاد أو تغيير السياسات، بل عبر إعادة تأويل الوقائع أو إنكارها أو تحميل أسباب الفشل لعوامل خارجية.
هكذا يصبح الخطاب المطمئن بديلاً عن الحقيقة المقلقة، وتغدو السرديات التبريرية وسيلة لتسكين التوتر بدل معالجة جذوره.
ضمن هذا الأفق التحليلي، تندرج حالة الدولة الجزائرية بوصفها حالة مركبة لا يمكن تفسير مسارها التاريخي ولا سلوكها الراهن بالاعتماد الحصري على منطق المصالح المادية أو توازنات القوة، بل تستدعي قراءة تركيبية تجمع بين تحليل الدولة والمؤسسات، وأنماط الحكم، والبيئة الإقليمية، مع الانتباه إلى البعد النفسي الرمزي بوصفه عاملًا مكمّلًا.
نشأت هذه الدولة في سياق تاريخي لم يسمح بتشكل تدريجي لدولة أمة، بل قامت ككيان سياسي بفعل هندسة استعمارية خارجية، حيث سبقت الحدود المجتمع، وسبق الجهاز السياسي الهوية الوطنية.
هذا التأسيس المختل ترك بصمته على بنية الدولة والمؤسسات، وأرسى علاقة ملتبسة بين السلطة والمجتمع، ظلت عاجزة عن إنتاج معنى سياسي جامع أو سردية وطنية مستقرة.
على المستوى السياسي والمؤسساتي، تركز الحكم الفعلي في يد طغمة عسكرية تمسك بمفاصل القرار الاستراتيجي، بينما أُسندت الواجهة السياسية إلى فاعلين مدنيين محدودي الصلاحيات.
هذا النمط من الحكم يُفضي إلى اختزال السياسة في بعدها الأمني، ويُنتج استقرارًا ظاهريًا يخفي في عمقه انسدادًا مؤسساتيًا وشعورًا اجتماعيًا متزايدًا بالاختناق، ما يعمق الفجوة بين الخطاب الرسمي وواقع الممارسة، ويغذي بدوره التنافر المعرفي الجماعي.
وعلى الجانب الاقتصادي، ترسخ الجزائر نموذج الدولة الريعية، لا بوصفه خيارًا ظرفيًا، بل كنمط حكم دائم. ورغم الموارد المالية الكبيرة، لم يتحقق تحول بنيوي مستدام، وبقي الاقتصاد أسير الاستهلاك والاعتماد على الخارج. في هذا السياق، تبرز مقاربة لعنة الموارد (Resource Curse) أو ما يشار إليه بالمرض الهولندي (Dutch Disease)، التي تبين كيف يمكن للوفرة، في ظل مؤسسات هشة، أن تتحول إلى عامل تعطيل بدل أن تكون رافعة للتنمية. ويسهم هذا الاختلال في تعميق التناقض بين خطاب الرفاه والسيادة من جهة، وواقع العجز والتبعية من جهة أخرى.
إقليميًا، أخفقت الجزائر في الاندماج ضمن مسارات تعاون بنّاءة، ومالت إلى مقاربة صراعية تزرع بذور الانقسام وتُبقي التوتر قائمًا. هذا الخيار لا يعكس فقط حسابات استراتيجية ضيقة، بل ينسجم أيضًا مع حاجة نفسية إلى تصدير الفشل (externalization of failure)، أي نقل أسباب الإخفاق من الداخل إلى الخارج، وتحويل الصراع إلى إطار دائم لتفسير العجز.
على الصعيد الاجتماعي والرمزي، أفضت هذه الاختلالات إلى فراغ في الهوية السياسية. لم يجد المجتمع في الدولة إطارًا رمزيًا جامعًا، ولا في السلطة أفقًا مقنعًا للمستقبل. هنا تتكاثر السرديات التعويضية، وتُضخم الرموز، ويُعاد تركيب التاريخ، لا بهدف الفهم، بل بغرض التسكين النفسي وتقليص التناقض بين صورة الذات وواقعها.
وتتجلى في هذا السياق مظاهر مرضية متعددة: تضخيم أعداد الشهداء وتحويل الخسارة إلى بطولة، تشويه الوقائع والكذب الإعلامي كآلية دفاع جماعية، وتطبيع العنف بوصفه لغة سياسية واجتماعية.
ويترافق ذلك مع شيوع منطق المؤامرة والبارانويا السياسية، بما يسمح بتخفيف القلق الجماعي دون معالجته فعليًا.
وهنا نعود إلى المشهد الافتتاحي: الخروج إلى الشوارع احتفالًا بهزيمة الآخر. لم يكن ذلك فرحًا عابرًا، ولا رد فعل بريئًا، بل علامة كاشفة على واقع لم يعد قادرًا على إنتاج إنجازاته الخاصة.
لحظة قصيرة بدت انتصارًا، لكنها في العمق كانت تعبيرًا عن عجز، وعن بحث يائس عن معنى يُستعار من الخارج حين يغيب من الداخل.
في المحصلة، تواجه الجزائر فشلًا مركبًا: دولة لم تُنجز انتقالًا مؤسساتيًا سليمًا، واقتصاد لم يحقق تحوّلًا إنتاجيًا، ونظام حكم لم يطور شرعية قائمة على الإنجاز، وسياسة إقليمية لم تبن تعاونًا مستدامًا.
ويبقى السؤال الجوهري معلقًا: كيف يمكن لدولة أن تواصل البقاء وهي تُراكم الإخفاقات، وتُسكن تناقضاتها عبر الوهم، وتُحول فشل الآخرين إلى مصدر فرح جماعي بدل بناء نجاحات ذاتية؟ الخطر هنا لا يكمن في انهيار مفاجئ، بل في بلوغ هذا النموذج حدوده القصوى، حيث يفقد النظام قدرته على إنتاج المعنى، أو تجديد شرعيته، أو حتى إدارة أزماته بالآليات القديمة. وهذا دليل على أن المسار برمته وصل في نهاية المطاف إلى الباب المسدود.
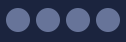 مشاهدة المزيد ←
مشاهدة المزيد ←