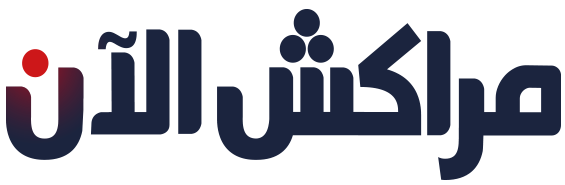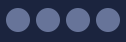لم يكن ما جرى، في نظر الأهالي، مجرد تحرك روتيني على خط حدودي، بل فعلا مستفزا يستحضر تاريخا طويلا من التوترات، ويصدم وجدان منطقة كانت في زمن مضى حضنا للمقاومين الجزائريين، حين كانت هذه الربوع مأوى للجرحى، وممرا للسلاح، ومخزنا للمؤونة، وملاذا للفارين من بطش الاستعمار الفرنسي.
إن هذا الحدث لا يمكن فصله عن سياقه العام، باعتباره حركة استعراضية فارغة المضمون الاستراتيجي، غايتها الاستفزاز وإثارة التوتر أكثر من تحقيق أي مكسب ميداني حقيقي، خصوصا في ظرفية دولية وإقليمية يواجه فيها النظام الجزائري ضغوطا متزايدة مرتبطة بملف الصحراء، وهو الملف الذي استنزف موارد هائلة على مدى عقود دون أن يحقق النتائج التي راهن عليها. ومن ثم تُفهم هذه التحركات بأنها محاولة لصناعة مشهد حدودي متوتر يُستثمر إعلاميا، لا خطوة عسكرية محسوبة النتائج، لأن المملكة المغربية تدرك طبيعة هذه المناورات وتتعامل معها بقدر عال من الانضباط الاستراتيجي؛ فهي جاهزة للدفاع بلا تردد، لكنها أذكى من أن تنجر إلى استفزازات تكتيكية معزولة.
إن واقعة قصر إيش ليست حادثة طارئة، بل حلقة جديدة في سلسلة تاريخية طويلة من الأفعال العدائية التي طبعها الغدر الجزائري في مقابل الدعم المغربي اللامشروط. منذ سنة 1844، دفع المغرب ثمن موقفه الداعم للمقاومة الجزائرية بقيادة الأمير عبد القادر، حين واجه الجيش الفرنسي في معركة إيسلي يوم 14 أغسطس من تلك السنة، وهي مواجهة غير متكافئة انتهت بهزيمة عسكرية أعقبتها ضغوط قاسية وقصف مدن مغربية وفرض معاهدة لالة مغنية في 18 مارس 1845 التي رسمت حدودا ملتبسة وقيدت دعم المغرب للمقاومة، لتترسخ تلك اللحظة في الذاكرة الوطنية المغربية بوصفها دليلا مبكرا على أن المغرب تحمل كلفة الدم والتراب دفاعا عن الجزائريين قبل أن تولد الجزائر الحديثة نفسها.
الصورة تتكرر، بعد قرن من الزمن، وخلال حرب التحرير الجزائرية بين 1954 و1962، لم يكن المغرب مجرد جار متعاطف، بل قاعدة خلفية حقيقية للثورة: فتح حدوده لعبور السلاح واحتضن معسكرات التدريب وعالج الجرحى واستقبل اللاجئين، كما سخر دبلوماسيته للدفاع عن استقلال الجزائر. وفي أبريل 1958 احتضنت طنجة مؤتمرا تاريخيا جمع قيادات مغاربية أعلنت دعمها لتحرير الجزائر.
في ذروة التوتر الدولي آنذاك، أدان الملك محمد الخامس علنا التجارب النووية الفرنسية التي أجريت في الصحراء الجزائرية، بدءا بتفجير الجربوع الأزرق في رقان يوم 13 فبراير 1960، ثم التفجيرات اللاحقة في الموقع نفسه، وبعدها تجارب عين إيكر ابتداء من نوفمبر 1961، معتبرا تلك الاختبارات خطرا على الإنسان والمجال المغاربي بأسره، رافضا تحويل أرض الجزائر إلى مختبر إشعاعي. لقد سجلت مراسلات دبلوماسية ومواقف رسمية احتجاج المغرب على تلك التفجيرات، عقبته أزمة دبلوماسية بين المغرب وفرنسا.
وفي ما يخص موضوع الصحراء الشرقية، تشير شهادات تاريخية إلى أن فرنسا، في عهد شارل ديغول، عبرت عن استعدادها لمراجعة وضع بعض المناطق الحدودية التي كانت قد ضمت إلى الجزائر الاستعمارية مقابل تخفيف المغرب دعمه للثورة الجزائرية أو التفاوض المباشر معها؛ غير أن الملك محمدا الخامس رفض أي ترتيب من هذا النوع، مفضلا أن يحسم الملف لاحقا في إطار تفاهم أخوي مع قادة الجزائر المستقلة، بدل أن يتم ذلك على حساب نضال شعبها، وجرى اتفاق بين المغرب ورئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك فرحات عباس تضمن اعترافا بوجود مشكل حدودي موروث عن الحقبة الاستعمارية، وتعهدا ببحث تسويته بعد الاستقلال.
غير أنه مباشرة بعد استقلال الجزائر سنة 1962 تمسكت القيادة الجزائرية الجديدة بمبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار، وهو ما شكل تراجعا عن الاتفاقات السابقة. ثم سرعان ما تصاعد التوتر إلى مواجهة عسكرية في خريف 1963، حيث اندلعت حرب الرمال ابتداء من 8 أكتوبر بعد مناوشات سابقة بدأها الطرف الجزائري، لقد تركزت الاشتباكات في مناطق حدودية منها حاسي بيضاء وتينجوب، قبل أن يعلن وقف إطلاق النار في 5 نوفمبر 1963، رغم تفوق الجيش المغربي، حقنا للدماء. وكانت الجزائر قد تلقت خلال تلك الحرب دعما عسكريا من أطراف خارجية، بينها مصر وكوبا، اللتان أرسلتا مئات الجنود مع تجهيزات عسكرية، فضلا عن دعم سياسي ولوجستي من المعسكر السوفييتي.
ثم جاء حدث 18 ديسمبر 1975، يوم عيد الأضحى، ليترسخ في الذاكرة المغربية كأحد أكثر الفصول إيلاما، حين ترحيل آلاف المغاربة قسرا من الجزائر، في ظرف أيام قليلة فيما عرف بالمسيرة السوداء، تاركين وراءهم ممتلكاتهم وأحيانا أفرادا من عائلاتهم. هذا الحدث لا يزال حاضرا في الوجدان الجماعي، باعتباره جرحا إنسانيا عميقا، يستعاد كلما طرح سؤال الثقة بين البلدين. منذ ذلك التاريخ، توالت محطات القطيعة والتوتر: نزاع الصحراء المغربية منذ 1975، إغلاق الحدود البرية سنة 1994، ثم قطع العلاقات الدبلوماسية في 24 أغسطس 2021.
غير أن عقدة الصحراء تمثل قلب هذا المسار ومفتاح تفسيره. منذ انسحاب إسبانيا سنة 1975، جعلت الجزائر هذا الملف محور سياستها الخارجية، فاحتضنت جبهة البوليساريو على أراضيها، ومنحتها قواعد خلفية، وسخرت لها دعما سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا واسعا، وحشدت لها المنابر الدولية، ووجهت لها إمكانات مالية ضخمة على مدى عقود. لقد وصف الرئيس الجزائري نفسه حجم الأموال التي صرفت في هذا السياق بتعبير “مال قارون”، في إشارة إلى ضخامة الموارد المرصودة. هذا الاستثمار الضخم لم يكن أبدا تضامنا مبدئيا، بل خيارا استراتيجيا طويل الأمد استنزف مقدرات الدولة الجزائرية وأموال شعبها في صراع خارجي، وجعل من قضية الصحراء أولوية ثابتة في سياستها الخارجية. ومن هنا يمكن اعتبار أن تشدد الموقف الجزائري كلما اقترب الملف من مراحل الحسم ليس إلا انعكاسا لحجم الرهان الذي وضع عليه طوال نصف قرن.
ولعل أبرز المشاهد التي تدل على تباين النوايا في العلاقة بين المغرب والجزائر المقارنة الرمزية بين موقفين يفصل بينهما أكثر من نصف قرن: في 9 دجنبر 1957 كان الملك محمد الخامس يدافع في خطابه بالأمم المتحدة عن استقلال الجزائر ويطالب بإنهاء الاستعمار عنها، بينما نجد حاليا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاباته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد دعم بلاده لأطروحة انفصال الصحراء عن المغرب!
ومع ذلك، وبالرغم من هذا الإرث المثقل بالتوترات، يظل المغرب متمسكا بخيار اليد الممدودة؛ إذ تكررت دعوات الملك محمد السادس الصريحة إلى فتح صفحة جديدة مع الجزائر، حيث دعا إلى طي صفحة الماضي وإجراء حوار مباشر وصريح، وإلى إعادة فتح الحدود وإطلاق تعاون ثنائي شامل. يقدم هذا التوجه في الرؤية المغربية، لا باعتباره مجاملة دبلوماسية، بل خيارا استراتيجيا ثابتا يقوم على قناعة بأن مستقبل المغرب الكبير لا يمكن أن يبنى إلا بتفاهم بين البلدين.
هكذا، لا تبدو العلاقة مع الجزائر مجالا لخلاف سياسي ظرفي، بل مسارا تاريخيا غير متوازن: دعم تاريخي وتضامن مكلف، يقابله جحود وقطيعة مستمرة.
إن حادثة إيش دليل على أن الأزمة ليست مسألة حدودية عابرة بقدر ما هي أزمة بنيوية تضرب جذورها بعمق في طبيعة غدر النظام الجزائري وعقيدته العدائية تجاه المغرب. تشير أبحاث في علوم الإدراك إلى أن بعض الخصوم يميلون إلى المخاطرة في مواجهة الفشل، أو أن الخصم الذي يواجه خطر احتمال اندلاع أزمة داخلية قد يرى أنه من الأسلم أن يبدأ بالهجوم…
ومع ذلك يظل الخطاب المغربي يصر على أن اليد التي امتدت يوما للدعم لا تزال ممدودة للحوار، وأن قوة الدولة لا تقاس بقدرتها على الرد فقط، بل بقدرتها على ضبط النفس في مواجهة الاستفزاز مع كونها في كامل الأهبة والاستعداد، وهي مقاربة استراتيجية تتوقف طبعا على قوة الرادع ومدى واقعية المردوع.